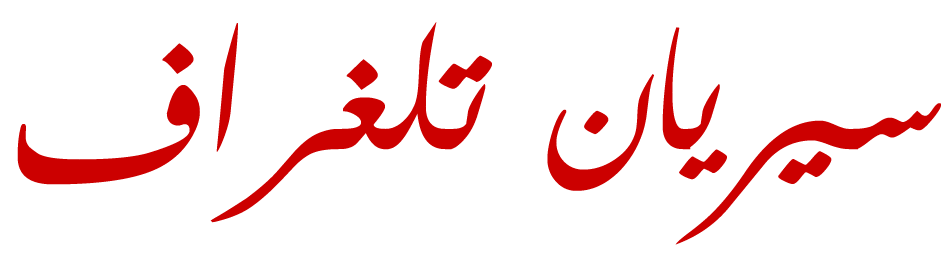مؤخرة ميريام فارس .. مقدمة ابن خلدون ! .. بقلم محمد رفعت الدومي
في البدء كانت الكلمة، شرف الإنسان هو الكلمة ..
هكذا قال أحد المتحذلقين، أظنه ” عبد الرحمن الشرقاوي “، و هو مزاح ثقيل، و كلام سخيف و فاشل و يجري في يقين الخطأ، و الصحيح أنه في البدء كان الانفجار العظيم لا الكلمة !
و في البدء ..
يجب أن أعترف بأن عنوان هذا المقال مسروقٌ من كهف ما من كهوف الذاكرة بتصرف، كأني ادخرته هناك لمثل هذا اليوم، ربما، يحالفني الحظ في العثور علي سبب وجيه لسرقته، و قد عثرت عليه أخيراً، مؤخراً، إنه مسلسل ” اتهام” الذي قامت ببطولته الفنانة “ميريام فارس” ، تلك التي مؤخرتها واحدةٌ من أجمل مؤخرات النساء من المحيط إلي الخليج إلي حد يؤهلها أن تكون في هذا السياق و الممثلة الأمريكية أرمينية الجذور “كيم كارداشيان”، هناك، حيث يعيش المنهكون بالترف و الحرية، كفرستي رهان، لكن، يبدو أننا، كعادتنا في التعامل مع كل شئ، لا نتوقف أمام التسويق لمؤخراتنا كأننا أم باب شديد الأهمية، بل مصرون نحن علي أن نحدق النظر في الموضوع برمته كشئ تافه لا يستحق إضاعة وقت أمثالنا، الثمين جداً، تماماً، كالبحث العلمي ..
كُتّاب كثيرون أيضاً سبقوني إلي ارتكاب سرقة هذا العنوان التي لا يجوز فيها القطع بصيغ مختلفة، كلٌّ حسب المؤخرة التي حاصرت ذهنه قبل الشروع في الكتابة، مؤخرة “روبي”، مؤخرة ” كيم كارداشيان “، مؤخرة ” نانسي عجرم “، لكن المقدمة كانت علي الدوام واحدة، مقدمة “ابن خلدون”، و هي بالنسبة إلي أيٍّ من هذه المؤخرات شئ تافه، كلام، فقط، كلام، و كل تافه لا يأتي إلا بصيغة واحدة، كالوطن العربي، إنه، فقط، الوطن العربي ..
و لست هنا بصدد الحديث عن مسلسل ” اتهام “، و لا بصدد الحديث عن الأضرار التي لحقت به بسبب ما انطوي عليه من ميوعة سردية و خط مرتبك و اقتداء صانعيه بأفكارهم المسبقة، لكن، برغم كل هذا، هو ليس الأسوأ بين أعمال “رمضان” ..
إنما، أنا هنا بصدد الحديث عن (اتهام) آخر وجهه بعض المؤرخين لـ ” ابن خلدون “، و بماذا؟، بالخيانة العظمي!
قبل أن أخوض في هذا الحديث أود أن أخوض في حديث آخر قصير ..
من الجدير بالذكر أن العلاقة بين “ابن خلدون” و “ميريام فارس” تتجاوز بطبيعة الحال تلك المفارقة اللفظية بين ” مقدمته ” و ” مؤخرتها ” كما قد يتبادر إلي الأذهان غير المسلحة بمئات من الكتب علي الأقل، فهما، قبل كل شئ، يحملان نفس الجنسية، جنسية ” لبنان “، من حيث الجغرافيا أولاً، و من حيث التاريخ قبل كل شئ !
فمن الثابت، أن ” تونس ” كانت أرضاً بكراً لم تطأها أقدامٌ قبل هبوط البحارة الفينيقيين في رحلتهم الشهيرة علي سواحلها، لذلك، هي تاريخياً أملاكٌ لبنانية، و جذور السكان الأصليين للبلدين واحدة، لكن الفوارق الرحبة بين ثقافة البلدين الآن، هي من صناعة موجات الهجرة المتكررة و مد الزمان وجزره لا غير ..
قد يقول قائل لا يعرف أن النسب ليس يعني فقط التواصل بين أبناء و آباء و أجداد عبر خط زمني ممتد، إنما هو ذاكرة الأرض ورائحة المكان قبل كل شئ، أقول، قد يقول قائل لا يعرف هذه الحقيقة :
أن ” ابن خلدون ” ليس تونسياً خالصاً، بل ليس تونسياً علي الإطلاق ، هو نفسه في كتابه ” كتاب العبر “، أو ” تاريخ بن خلدون “، طارد جذور عائلته حتي ” حضرموت ” و ردَّ نسبه إلي الصحابيِّ ” وائل بن حجر “، و هذا ادعاء، يدرك كل الذين استوعبوا أبعاد شخصية ” ابن خلدون ” كاملة، ألا أساس له من الصحة، أو علي الأقل، مشكوك في صحته، و حتي الآن لا أحد يدري ما وراء كواليس هوسه بمسألة النسب تحديداً، و هو هوس يكاد أن يمسكه بيديه كلُّ من قرأ تراث الرجل، لكن، من قال أن ” ميريام فارس ” لبنانية خالصة، هذه المؤخرة الجهمة بالقياس إلي رقة قوامها أرمينية الجذور علي الأرجح، تماماً، كمؤخرة ” كيم كارداشيان “، تلك الكتلة الحرجة من العضلات و الأنسجة فوق ذاك الغصن الرقيق لا تتشكل أبداً من تلقائها، و لابد أن هناك معلومات محفورة في جينات مستوردة كانت السبب في كل هذا الجمال، و جمال مؤخرات نسائها يكاد أن يكون عرفاً دارجاً في ” أرمينيا”، لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي!
لكن، ” ميريام فارس ” مسيحية أرمينية، أو هكذا أظن، و إن كان يدهشني أن اسم أبيها ” فارس ” فقط لا ” فارسيان “، فالألف و النون آخر كل اسم بعض تناذرات الأرمن الشهيرة، و لكن، مرة أخري، الراقصة الأرمينية ” صافيناز ” تقطع في هذا السياق قول كل خطيب، تماماً، كـ “جهيزة ” ..
و الآن، إلي جوهر هذا الكلام..
في بداية القرن الخامس عشرالميلادي، عام ” 1401 ” تحديداً، حدث أن طرق الغازي المغولي الرهيب ” تيمورلنك ” أبواب مدينة ” دمشق ” ..
كان قد استولي قبل ذلك بشهور علي مدينة ” حلب ” و سحق أهلها، و عصف بالكثير من الأرواح الهشة و الأحلام المؤجلة، و كتب نهاية مأساوية للعديد من قصص الحب و الوعود الصغيرة، و باشر تربية الذعر في القلوب من كل جانب!
علي الساحل الآحر،
السلطان المملوكي ” فرج “،
و أجدني، منذ مرحلة عمرية مبكرة و حتي كتابة هذا الكلام، لا أستطيع أن أستسيغ أن يكون سلطاناً و يكون اسمه ” فرج ” في نفس الوقت، لكنها الحظوظ، و لعله هو المصدر الجذري لاسمي ” فرج ” و ” فرج الله ” كثيري التداول في جنوب مصر حتي أعوام مضت، و لا أعرف أحداً في التراث ابتلي بهذا المرض قبله، و إن كان هناك اسم ” أبي الفرج “، سكن العديد من الشخصيات التراثية البارزة، مثل، ” أبي الفرج الأصفهاني” و ” أبي الفرج بن الجوزي ” و ” أبي الفرج الوأواء الدمشقي ” ..
تماماً، كاسم آخر لا أحبه، مع ذلك، فضلت في طفولتي التعايش السلمي مع كثيرين يحملونه، ألا و هو اسم ” شعبان “، فثمة سلطان مملوكي آخر كان مريضاً باسم ” السلطان شعبان “، علي كل حال، يبدو أنني أحسن حظاً لأني نجوت من التعايش السلمي مع ” قنصوه ” مثلاً، و ربما، كان المصريون أخبث مما أظن و حرموني من نيل هذا الشرف، و يكون اسم ” خنُّوس ” هو تحريف لاسم ” قنصوه “، من يدري، فإن للمصريين أحوال ..
و الشئ بالشئ يذكر..
سمعت أن امرأة من قريتي، في نهاية منتصف العام الماضي، أيام كان ” السيسي” يختبئ خلف صمته، و قبل أن تتبخر كل الأوهام و يتعري الفراغ، أطلقت علي ابنها اسم ” سيسي “، علي كل حال، سيرة هذه المرأة في كل بيوت القرية المغلقة علي الأسرار تزكم الأنوف، حتي الأطفال يعرفون هذا، و هي لمن لا يعرف من الغرباء، و شاهد فيلم ” محامي خلع “، بالضبط، نسخة قريتنا طبق الأصل من ” مرات عوض أبو شقفة “!
” فرج “، ” السلطان فرج “، أو كأنه ” السلطان فرج “،
علي الساحل الآخر، أحسَّ بالخطر علي الأمن القومي لأملاكه في ” مصر ” و ” الشام “، و قرر أن يواجه ارهاب ” تيمورلنك ” المحتمل، و اصطحب معه إلي ميدان المعركة عدداً كبيراً من قضاة السلطان و فقهاء السلطان، و كان ” ابن خلدون ” من بينهم!
المهم ..
هناك، حين أحس ” فرج ” بصلابة عدوه، و بجسامة الورطة التي سعي إليها بقدميه، ادعي أن مؤامرة تحاك ضده في ” مصر”، و انسحب بكل جيوشه تاركاً ” دمشق ” و أهلها و معظم من اصطحبهم معه من المدنيين تحت وطأة ” تيمورلنك “!
هؤلاء، أرادوا تسليم المدينة، غير أن ” نائب القلعة ” أبي إلا الدخول في معركة أياً كانت الخسائر، و لأن المسافة بين وجهتي النظر كانت كبيرة، حدث خلاف كبير واتهامات متبادلة، و لعل ” ابن خلدون “، بوصفه شاهد عيان، يجيد الكلام عما حدث أكثر مني، بل تكاد تشم من كلامه رائحة الأدرينالين تفوح من كل مكان في ” دمشق “، يقول في كتابه ” التعريف” :
” و بلغني الخبر من جوف الليل، فخشيت البادرة على نفسي، و بكرت سحراً إلى جماعة القضاة عند الباب، و طلبت الخروج أو التدلي من السور، فأبوا علي أولاً، ثم أصخوا لي، و دلوني من السور، فوجدت بطانة تيمور عند الباب، فحييتهم و حيوني، و قدموا لي مركوباً، أوصلني إليه، فلما وقفت بالباب، خرج الآذن فاستدعاني، و دخلت عليه بخيمة جلوسه، متكئاً على مرفقه، فلما دخلت عليه فاتحته بالسلام، و أوميت إيماءة الخضوع، فرفع رأسه و مد يده إلي فقبلتها، و أشار بالجلوس فجلست حيث انتهيت، ثم استدعى من بطانته الفقيه ” عبدالجبار بن النعمان “، من فقهاء الحنفية بخوارزم، فأقعده يترجم بيننا “
لهذا السبب وحده، اتهم بعض المؤرخين الفاشلين ” ابن خلدون ” بالخيانة، و هؤلاء، هم هم، لم يرجموا بالخيانة سيرة ” السلطان فرج ” نفسه، ( صاحب الفرح ) !..
كما أن ” القاضي برهان الدين بن مفلح الحنبلي ” و معه شيخ الفقراء و آخرون، فعلوا مثلما فعل ” ابن خلدون “، و طلبوا من ” تيمورلنك ” الأمان، و في ذلك يقول ” ابن خلدون “:
” فأحسن لقاءهم، و كتب لهم الرقاع بالأمان، و ردهم على أحسن الأحوال، و اتفقوا معه على فتح المدينة من الغد، و تصرف الناس في المعاملات “!
ثم بقي ” ابن خلدون ” في بلاط ” تيمورلنك” حين انهارت أسوار ” دمشق “، و خلصت لمالكها الجديد، و هو يصف ما حدث بعد ذلك قائلاً :
” ثم أطلق أيدي النهابة على بيوت المدينة، فاستوعبوا أناسيها وأمتعتها، و أضرموا النار فيما بقي من سقط الأقمشة، فاتصلت النار بحيطان الدور المدعمة بالخشب، فلم تزل تتوقد إلى أن اتصلت بالجامع الأعظم، و ارتفعت إلى سقفه، فسال رصاصه، و تهدمت سقفه و حوائطه، و كان أمراً بالغاً مبالغة في الشناعة والقبح “
بالإضافة إلي أن ” ابن خلدون ” تدلي من فوق أسوار ” دمشق ” في ( قفة )، مخافة الموت، و ذهب إلي معسكر ” تيمورلنك “، هو أيضاً، رسم لـ ” تيمورلنك “، عن طيب خاطر، خرائط مفصلة لبلاد المغرب، و كتب له كل شئ عن أحوال أهلها في حزمة كراسات، بلغت، ” 12 ” كراساً !
” ابن خلدون ” نفسه هو الذي قال هذا الكلام بلهجة صريحة و حادة و فارغة من أي موجة من الإحساس بالذنب ضربت للحظة حواسه للعب دور الجاسوس !
و أنا، لا أريد هنا أن أنفي عن ” ابن خلدون ” تهمة النفاق، إنما أريد تأكيدها، فالرجل، بلا مراء، كان واحداً من المنافقين العظام، و من الانتهازيين الرواد، و هو، في كثير مما نزف قلمه، يورط نفسه عن عمد، بكل بساطة، في شرخ هذه التهمة، كأنه يصف نفسه بالكرم مثلاً، بل كأني به كان يضحك في حبور أثناء الكتابة، من ذلك، يقول:
” فوقع في نفسي لأجل الوجل الذي كنت فيه أن أفاوضه في شيء من ذلك ليستريح اليه، ويأنس به مني، ففاتحته و قلت :
– أيدك الله، ليَ اليوم ثلاثون أو أربعون سنة أتمنى لقاءك، فقال لي الترجمان ” عبد الجبار ” :
– و ما سبب ذلك ؟
فقلت :
– أمران، الأول أنك سلطان العالم، و ملك الدنيا، و ما أعتقد أنه ظهر في الخليقة منذ آدم في العهد مثلك، و لست ممن يقول في الأمور بالجزاف!” ..
كما ترك لنا ” ابن عربشاه ” في كتابه ” عجائب المقدور في نوائب تيمور ” وشاية واضحة تؤكد أن النفاق كان يلمع في شخصية ” ابن خلدون ” كالخنجر..
لقد حدث خلال مائدة أقامها ” تيمورلنك” لفقهاء ” دمشق ” الذين زاروه لإظهار الخضوع و الطاعة لوليِّ النعم الجديد، و هذا شأن الفقهاء في كل زمان و مكان، فهؤلاء، علي طول التاريخ و عرضه، كانوا في صف ” اللي طابخ “، و من يملك ” المضيرة “، و هؤلاء كانوا منشغلين بالتهام الدهن حين قال ” ابن خلدون “، الأعلي من هؤلاء كعباً بطبيعة الحال، و لا يعنيه ما يعنيهم من أشياء الطفيليين، قال :
” شهدت مشارق الأرض، و مغاربها، و خالطت في كل بقعة أميرها ونائبها، و لكن لله المنة أن امتد بي زماني، و منَّ الله عليَّ بأن أحياني حتى رأيت من هو الملك على الحقيقة، و المسلك بشريعة السلطنة على الطريقة، فإن كان طعام الملوك يؤكل لدفع التلف، فطعام مولانا الأمير يؤكل لذلك، و لنيل الفخر والشرف “!
من ذا الذي لا يصف الرجل بعد كل هذا بالنفاق و يجوز لنا أن نتهمه بسلامة العقل ؟
مع ذلك، لابد من التفكير خارج التابوت أحياناً ..
مما لا شك فيه أن” ابن خلدون ” هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع، لا كما يزعم الأوربيون، الفيلسوف الفرنسي ” أوجست كونت “، وإن كان الأخير هو من صاغ هذا التعبير و وضعه في إطاره المتعارف عليه الآن ..
و من أجل احترام المنطق، يجب أن نكون علي ثقة من أن أفكار الرجلين التي اتخذ كلاهما منها نواةً لهذا العلم أطول عمراً منهما بكثير، و هي أفكار تقف علي جذور ضاربة في القدم، و مستمدة من ثقافات إنسانية متباينة، و متقاطعة أحياناً ..
و هو علم في رأيي لم يزل في طور الطفولة، لذلك، لم يستطع حتي الآن أن يستوعب الأبعاد الكاملة للتحولات الاجتماعية العصبية للجماعات، و لا أن ينسجم مع الحداثة فضلاً عما بعد الحداثة، و لا أن يهدئ من وتيرة التفكك الاجتماعي المتسارعة، لكن علماء الاجتماع معذورون، فالتحولات الاجتماعية في العقود الأخيرة تتضاعف يومياً، كالورم، لأسباب كثيرة، في ” مصر ” مثلاً، بفضل بعض الأوغاد و لصوص الحريات، بطقس بسيط، أصبح في ” مصر “، بعد عدة ساعات من مذبحة ” رابعة العدوية “، مجنمع مواز للمجتمع المصريِّ، أقدم مجتمع في التاريخ المدون، بكل معني كلمة ” موازي “، أقصد، مجتمع ” رابعة العدوية “، و هو مجتمع متحرك يربح سكاناً جدد كل صباح، و يترهل، و سوف يحتل المقدمة بكل تاكيد، فلم يحدث عبر العصور أن أُهدرت دماءٌ وراءها موتورٌ يقظ، و مزدحم بالتصميم في نفس الوقت ..
أيا كان الأمر، أواصل :
مؤسس هذا العلم هو ” ابن خلدون ” طبعاً، لذلك، كان يجب أن يكون من دعاة الاستقرار كقيمة دونها كل قيمة، و هذا يقتضي بالضرورة أن يحدق النظر في كل ما يمت إلي كلمة ” حرب ” بعيون النقمة، و هي كراهية تتحد بالطبع بكراهيته لكلمة ” ثورة “، كفعل أو كرد فعل، لكن شخصاً يفكر كما يفكر هو، لابد أن يستدير، حين تنجح الثورة في تبني قوانينها الخاصة من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار، بل يصبح ثائراً أكثر من ” جيفارا “، و تتبدل نظرته لها علي الفور، و لقد حدث هذا بالفعل !
فعلي الرغم من أنه كان في كل ما كتب ضد الخروج علي الحاكم و إن كان ظالماً، من أجل الاستقرار و عجلة الإنتاج طبعاً، غير أنه أشاد بقوة بثورة القائد الأمازيغي ” محمد بن تومرت ” مؤسس دولة الموحدين بعد أن نجحت و أكملت كل دوائرها، للسبب نفسه، الاستقرار بصيغة أخري، و في ظلال أخري، ظلال المنتصر الذي بمقدوره أن يجلب الاستقرار ..
كأنه كان يري أن دولة المرابطين بعدما تحطمت لم تعد صالحة للوقوف في صفها، و صارت عقبة في طريق الاستقرار، باختصار، هو يري أن الطاعة يجب أن تكون تعبيراً محميَّاً فقط للمنتصر، و الأقوي، و هو رأيٌ للنفاق في طياته نبضٌ أكيد، مع ذلك، ربما يغفر له كل ما اقترف من نفاق أنه كان رجلاً متصل الظاهر بالباطن، واظب علي حراسة أفكاره المعلنة حتي الموت، و دوَّنها حفراً في الورق، دون خجل !
ألا ليت الكثيرين من مثقفي هذا الزمان يتمتعون ببعض هذا الخُلُق، و يتوقفون عن أن يكونوا معارضين أو مؤيدين تحت الطلب، ليت..
أيضاً، ربما يغفر له كل ما اقترفه من نفاق، تلك النظر الدونية التي كان يخلعها علي كل ما هو عربيٍّ، كجنس قبل كل شئ، و لقد أثبتت الأيام أنه كان يتكلم من قلب الحقيقة، و أنه كان مسخاً، و سابقاً لأوانه، و هو هو، أول من صرح، مبكراً، مبكراً جداً، بأنه من الإحالة، بل المبالغة فيها، ذلك الرأي القائل بأن الخلافة يجب أن تكون حكراً علي المنتمين إلي ” قريش “، كان هذا التصريح حجراً ألقاه في ماء التراث الآسن فثارت له فيما بعد سواحل بعيدة !
لكل ذلك، لم أنجرف أبداً في تيار الذين رجموا ” ابن خلدون ” بالخيانة، و للأسف، كان ” طه حسين ” من بين هؤلاء، لقد خاض فيه، لكن، برهافة شديدة، قال عنه :
– ” يتأثر أحياناً بعامل المصلحة الشخصية فيحيد عن طريقته ” ..
أكثر من هذا، أري أن ما فعله مع ” تيمورلنك ” ينسجم تماماً مع شخصيته، وهو الأشبه بخرزته التي اختارها من العقد، و كل الطرق بعد هذا الطريق إلي سريرة ” ابن خلدون ” تتخثر إما إلي الجهل أو التجني ..
و الآن، لحظة من التفكير السليم، خارج التابوت، هي كل ما نحتاج لنجيب، من الداخل، علي هذه الأسئلة ..
ماذا كان علي ” ابن خلدون ” أن يفعل سوي ما فعل ؟
ما هو الفارق بين الولاء للسلطان ” فرج ” و بين الولاء لـ ” تيمورلنك” و كلاهما محتل و مغتصب للأرض و مقدرات الناس بالقوة المسلحة ؟
هل كان علي ” ابن خلدون ” أن ينتظر الموت المجانيَّ في سبيل قيم موروثة لا تقيم للعدالة الاجتماعية وزناً في سبيل الولاء لـ “وليِّ أمر ” هو نفسه لاذ بالفرار من أرض المعركة لمجرد إحساسه بالخطر ؟
كل هذه الأسئلة، مغ التفكير السليم، يجب أن تنكمش إلي براءة ” ابن خلدون ” من تهمة الخيانة، بل حتي من ظل هذه التهمة، و تنسحب بالضرورة إلي إدانة واضحة للنظام في عصره، و تؤشر إلي قيمة مهمة، و هي أن خيانة كل نظام يتربص بإنسانيتك، و يراقب أنفاسك، و يؤمن إلي مدي بعيد بأنك ولدت لتكون من طبقة العبيد الدنيا، و إلي مدي أبعد، بحقه الإلهيِّ في سرقة رجولتك و طفولة أطفالك أمام عينيك، أقول، خيانة هكذا نظام هي لون من ألوان المقاومة ..
بل، عارٌ عليك أن ينام هكذا نظام ملْ جفونه و هو يتوقع منك الطاعة، بل الصمت ..
إقلع غماك يا تور، و ارفض تلف /
إكسر تروس الساقية، و اشتم وتف ..
سلامٌ علي ” صلاح جاهين “، و عذراً ” ميريام فارس “، الوردة الطليعية ..
سيريان تلغراف | محمد رفعت الدومي
(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)