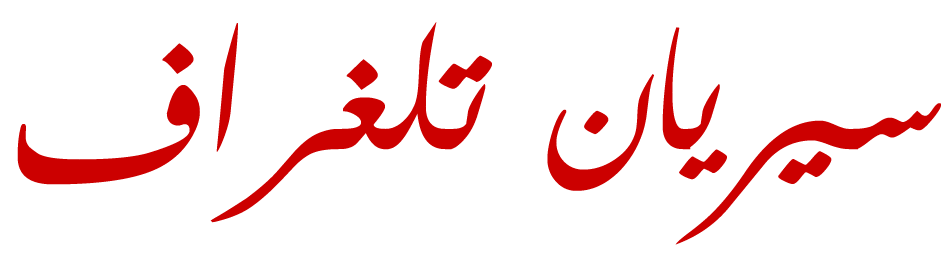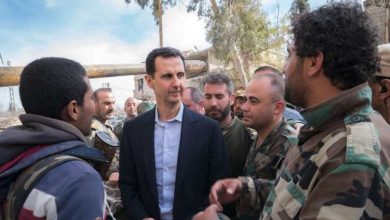الأخبار : عودة إلى عصر المحميات في الخليج
وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند صرّح في 10 نيسان الجاري بأن المملكة المتحدة تنظر في خيارات تأسيس قاعدة عسكرية دائمة في منطقة الخليج. وأجاب هاموند على سؤال لصحيفة «غولف تايمز» في الدوحة حول الوجود العسكري البريطاني في المنطقة، وقال: فيما تسحب المملكة المتحدة قواتها من ساحات القتال في أفغانستان من المؤكّد أن واحدة من هذه الخيارات هي تأسيس قاعدة دائمة في مكان ما في الخليج.
لم يكن تصريحاً خارج السياق، فهو يشي بما هو أكبر من مجرد قاعدة عسكرية، أو حتى زخم الوجود العسكري البريطاني بتسهيلات جديدة على غرار ما جرى الحديث عنه في 28 آذار الماضي بشأن نيّة بريطانيا توسيع مركز قيادة البحرية الملكية في العاصمة البحرينية، المنامة، في سياق تعزيز الحضور العسكري البريطاني في البحرين. ومن المعروف، أن منطقة الشرق الأوسط تضم ثاني أكبر وجود للقوات البحرية الملكية البريطانية والذي يشتمل على 10 من أصل 32 بارجة حربية في المنطقة. ويتموضع الوجود العسكري البريطاني في البحرين بالقرب من قاعدة الاسطول الخامس الأميركي.
هنا تبدو المعلومة معزولة ما لم نضعها في سياقها الصحيح، ولا بد من عملية سرد للحوادث بطريقة منطقية.

زيارة أوباما إلى الرياض في 28 آذار الماضي فشلت شكلاً ومضموناً، وهي نتيجة كانت متوقعة قبل أن تبدأ. ولكن ليس هنا بيت القصيد، فثمة معطيات وقرائن تفيد بتحوّل استراتيجي كبير في المرحلة المقبلة… اختصرت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس هذا التحوّل في تصريحها الشفاف لصحيفة «نيويورك تايمز» في 26 تشرين أول 2013، حين عرضت لمراجعة سياسة الولايات المتحدة في المنطقة الأكثر اضطراباً في العالم، بحسب وصفها. وأوضحت أن هدف الرئيس أوباما الحيلولة دون السماح لحوادث الشرق الأوسط أن تبتلع أجندة السياسة الخارجية، كما كان الحال بالنسبة للرؤساء من قبله. وقالت رايس ما نصّه: «لا يمكننا أن نُستهَلك 24/ 7 من قبل منطقة واحدة، مهما كانت أهميتها». وأضافت «يعتقد ـ الرئيس أوباما ـ بأن الوقت كان مناسباً للتراجع للوراء وإعادة التقييم، بطريقة نقدية للغاية وغير مقيّدة، وكيف يجب أن ننظر الى المنطقة». وتحدّثت رايس عن رغبة أوباما في الرعي في مكان آخر، وتحديداً شرق آسيا. وبحسب قولها «ثمة عالم بأسره هناك ولدينا مصالح وفرص في هذا العالم».
نشير هنا إلى تقرير صدر أخيراً عن مجلس الاستخبارات الوطني في أميركا يستشرف مستقبل القوات العسكرية الاميركية في منطقة الخليج، وتوقّع التقرير تراجعاً تدرّجياً لهيمنة الولايات المتحدّة، وصوّر وضع الأخيرة بأنها ستكون «الأولى بين متساويين». وذكر التقرير بأن الولايات المتحدة ستعيد النظر في استراتيجيها في المنطقة، على ضوء التوقعات بأن تصبح أميركا أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وأن احتياطها ارتفع من 30 عام الى 100 عام بفضل التكنولوجيا الحديثة، كما أن انتاجها النفطي سوف يؤهلها لأن تكون مصدّراً للنفط بعد أن كانت مستورداً له، حيث لا تتجاوز صادرات النفط والغاز من الخليج الى أميركا 11%.
قد لا تعكس هذه التصريحات الصورة الكاملة عن الاستراتيجية الأميركية الجديدة، ولكنها بالتأكيد تلفت الى رؤية مختلفة تعتنقها الإدارة الأميركية حيال المنطقة.
إن كل ما قيل عن مناكفات سعودية حيال التغيير الدراماتيكي في الموقف الاميركي من الأزمة السورية، والاتفاق النووي الاميركي ـ الإيراني مجرد قراءة سطحية، ففي العمق يتم إرساء أسس لشراكة استراتيجية جديدة.
لا الصين ولا روسيا ولا أي قوة أخرى مصنّفة على المعسكر الآخر يمكن لها ملء الفراغ في مرحلة انتقال الولايات المتحدة من المنطقة إلى أقاصي الشرق.
زيارات بندر بن سلطان الى موسكو وولي العهد سلمان بن عبد العزيز الى بكين لم تكن لجهة بناء تحالفات استراتيجية، بل كانت، من بين أهداف أخرى اقتصادية وعسكرية، تأتي في سياق لفت نظر الشريك الأميركي واستدراج حلفاء الأمس خصوصاً بريطانيا، ولم تكن ـ تلك الزيارات ـ ترتقي الى مستوى الشراكة الاستراتيجية. فثمة في الرياض من يدرك تماماً أن بوصلة التحالف موجّهة نحو الغرب فحسب… ولكن هذه المرة سوف يكون الغرب الأوروبي هو البديل.
في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دبلوماسيين أوروبيين من بينهم السفير الفرنسي في الرياض التقوا الأمير بندر بن سلطان قولهم إن الأخير أبلغهم بأن «الرياض بصدد إحداث تغيير كبير في علاقتها مع واشنطن احتجاجاً على عدم تحركها بشكل فعّال فيما يخص الأزمة السورية». ونقلت الصحيفة عنه قوله إنه ينوي التراجع عن الشراكة القائمة مع السي آي أيه لتدريب الجماعات المسلّحة في سوريا، و»العمل مع حلفاء آخرين»، وذكر فرنسا والأردن.
تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات العامة والسفير في لندن وواشنطن سابقاً، وأكثر الأصوات المسموعة في الغرب، أطلق تصريحات ناقدة للسياسة الاميركية في الشرق الأوسط، وخصوصاً في ما يتعلق بالملفين السوري والايراني، ولفت بطريقة غير مباشرة الى تغيّر في وجهة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وحلفائها الغربيين.
على عكس ما يظن البعض، فإن السعودية بدأت تفكّر جديّاً في تنويع مصادر الحماية، تأسيساً على تحوّلات جديّة في الاستراتيجية الأميركية. الولايات المتحدة أمام استحقاقات اقتصادية واستراتيجية ذات أهمية كبيرة، ومن أبرزها اكتشاف النفط الصخري، الذي يجعل منها الدولة النفطية الأولى في العالم عام 2015، ما دفع بشركة النفط السعودية «أرامكو» إلى تخصيص موازنة سخيّة بهدف إعداد خطة لمواجهة هذا التحدي. حين يوضع ذلك جنباً الى جنب مع ما كشفت عنه مستشارة الأمن القومي رايس بخصوص نقل الثقل الأكبر من السياسة الخارجية الأميركية نحو الشرق الأقصى، نكون أمام مرحلة جديدة لا يكون فيها للشراكة الاستراتيجية وفق المفهوم القديم معنى.
في حقيقة الأمر، أن اسرائيل والسعودية في مقدمة الدولة المستهدفة بالتحوّل في الاستراتيجية الأميركية، وقد شعرا به في مرحلة مبكرة، وعبّرا عن القلق إزاءه.
لم يعد كلام الملك فيصل (حكم من 1962 ـ 1975) للسفير الأميركي الأسبق في السعودية باركز هارت (نحن من بعد الله نثق بالولايات المتحدة الأميركية) صالحاً الآن، فثمة تبدّلات طاولت الأسس التي قامت عليها معادلة الحماية مقابل النفط، وأن مراكز الجاذبية الاقتصادية والاستراتيجية لم تعد في نظر الولايات المتحدة كما كانت عليه خلال نصف القرن الماضي، ما يتطلب التخلي عن بعض مناطق النفوذ لصالح الشركاء الأوروبيين. لقد طاول التباين بين واشنطن والرياض ملّفات عديدة، وحتى قائمة الاعداء لم تعد هي كما كانت قبل أشهر، فأعداء السعودية اليوم من الدول: إيران، والعراق، وسوريا، وتونس، والسودان، ومن الجماعات: الاخوان المسلمين، وحزب الله، والحوثيين. والقائمة تبقى مفتوحة طالما أن ثمة دولة أو جماعة تقف على النقيض مع توجّهاتها السياسية. بالنسبة لواشنطن، ليس الأمر على هذا النحو، فايران تقترب من تفاهم نووي مع الغرب، وقد يؤول إلى فتح الأسواق الإيرانية أمام الشركات الأميركية المتعطّشة لهذه الفرصة، والعراق لا يزال دولة حليفة لولايات المتحدة، وليست هناك عقدة لدى الأخيرة من وصول الاخوان المسلمين الى السلطة سواء في تونس أو في أي مكان آخر.
في ضوء ما سبق، يبدو البحث عن تحالفات بديلة مساراً سعودياً لا مناص منه. وتبدو بريطانيا، بوصفها أبرز قوى الانتداب القديمة عموماً، الخيار الأوفر حظاً وترجيحاً لدى السعودية، فيما تأتي فرنسا في المرتبة الثانية.
من الناحية التاريخية، تعتبر بريطانيا، صانعة وراعية للمشيخات في الخليج، وهي من ساهم في إرساء أنظمة أوليغارشية من خارج حركة التاريخ. ولا غرابة في أن تبقى هذه المحميات الاستثناء في أي تحوّل ديمقراطي، بفعل معاهدة الحماية التي تجعل هذه الكيانات مصونة إزاء أي ضغط دولي لجهة احترام حقوق الانسان، ووضع تشريعات تمهد لانتقال ديمقراطي، أو اجتراح آليات حيوية لناحية تغيير شكل الحكم والتداول على السلطة.
لا ريب أن بريطانيا التي كانت أكثر دول الاتحاد الاوروبي حماسة للانفتاح على إيران تضع نصب عينها على الخليج مجدداً، من أجل عودة مريحة الى ساحل الذهب الأسود. استعجلت لندن الانفتاح على طهران، وهي التي حزنت لقرار الأخيرة تخفيض مستوى العلاقات بين البلدين الى أدنى مستوياتها قبل سنوات.
وفي ظل تحدي وجودي تواجهه بريطانيا حيث تفيد التوقعات بتصويت سكّان مقاطعة اسكتلندا على الاستقلال وما ينطوي ذلك على خسائر فادحة لاقتصاد بريطانيا ودورها الحيوي في السياستين الأوروبية والدولية، فإنها أمام خيارات صعبة تفرض عليها البحث عن مصادر قوة بديلة.
بريطانيا هي الأقرب الى روح السياسة الاميركية، والأقدر على ترجمة اهدافها في المنطقة، دع عنك فهمها الدقيق لمشكلات المشيخات الخليجية.
البحرين، على سبيل المثال، كانت قبل الانتداب وبعده خاضعة للرعاية البريطانية وهي التي لم تكف عن تزويد العائلة المالكة في البحرين بكل ما تحتاجه من مشورات ودعم لوجستي لبقاء النظام الخليفي متماسكاً في مواجهة الثورة الشعبية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات.
بالنسبة لفرنسا، التي لم يكن لديها حضور عسكري في الخليج، ولم تكن جزءاً من تاريخ الانتداب الاجنبي في المنطقة، نجحت في بناء شراكة استراتيجية مع كل من الامارات والسعودية، ما يجعلها مرشّحة لأن تشكّل الى جانب بريطانيا نظام حماية ثنائي قادر على ملء الفراغ بعد غياب الولايات المتحدة من المنطقة.
صحيفة «لوموند» الفرنسية كتبت في 29 كانون أول الماضي تقريراً عن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى الرياض، ووصفت هولاند بأنه «الحليف الغربي الأفضل بالنسبة للمملكة العربية السعودية»، منذ انقلاب أوباما على قرار توجيه ضربة عسكرية لسوريا في أيلول من العام الماضي، والميل الى عقد اتفاق مع ايران، الخصم العنيد للسعودية.
نشير إلى أن ثمة توافقات فرنسية ـ سعودية بشأن ملفات عديدة: إيران، سوريا، لبنان تجعلهما أقرب الى الشراكة الاستراتيجية. كانت زيارة سعود الفيصل وبندر بن سلطان الى باريس في 12 حزيران 2013، بهدف تنسيق المواقف بعد سقوط مدينة القصير السورية ذات دلالة مهمة، إذ أبدت فرنسا هولاند تشدّداً مبالغاً في الملفين السوري والإيراني. التوافق في المسألة اللبنانية كان واضحاً بين باريس والرياض، وقد يسهّل مهمة حلفائهما من فريق 14 آذار. صحيفة «الرياض» كتبت في 29 كانون أول الماضي، أي في اليوم الذي زار فيه هولاند الرياض، بأن استقبال الملك عبد الله الرئيس الفرنسي هولاند في مقر إقامته بروضة خريم قرب الرياض «يعد حسب المطلعين على سجل الشراكة الاستراتيجية السعودية ـ الفرنسية…». وقد شهد التعاون بينهما تطوّرات كبرى في مجالات التسلّح والصناعة والصحة والتجارة، وحصلت فرنسا على عقود مغرية لتحديث القوات البحرية السعودية بما في ذلك تزويدها بغواصات والتأهيل القتالي.
الزيارات المكثّفة التي يقوم بها مسؤولون فرنسيون وبريطانيون في الآونة الأخيرة ليست بالتأكيد بروتوكولية، فأهدافها، بالنظر الى كل المعطيات الواردة في هذا المقال، تؤشر الى مرحلة جديدة تشهد غياب قوى وحضور أخرى. ما ظهر حتى الآن هو الوتيرة السريعة للانفاق العسكري وكثافة الجيوش الأجنبية التي سوف توجد في المنطقة بهدف حماية المشيخات الخليجية من مخاطر، في الغالب محليّة، وعلى وجه الخصوص من دعاة الحرية والمدافعين عن حقوق الانسان وأنصار الديمقراطية.
سيريان تلغراف | صحيفة “الاخبار” اللبنانية